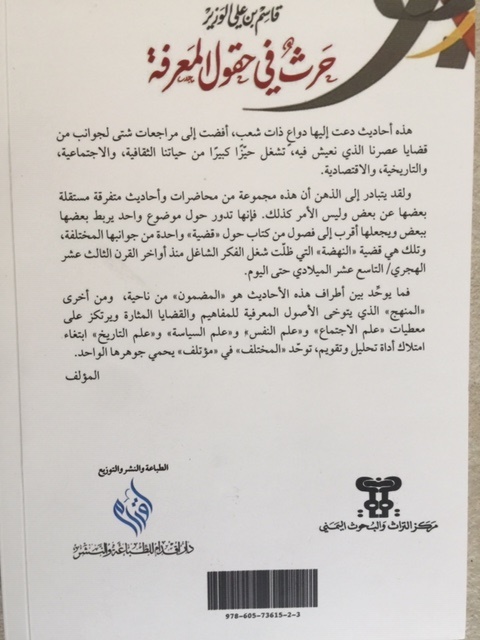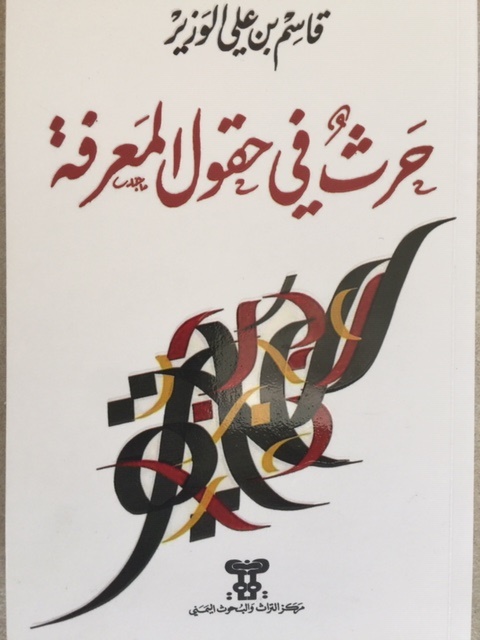فأمّا الكاتب فهو شقيق، ورفيق طريق، سرنا معًا منذ سقوط الثورة الدستورية عام ١٣٦٧/ ١٩٤٨م حتى الآن في ظروف سادتها العواصف الهائجة، فبدلت من يُسْرِنا عُسرًا ، وأذاقتنا مراً ، فلم تتوقّف خطانا مع مَنْ سبقنا من الأحبة، ولم نغيّر من اتجاهنا "الدّستوري" خطوة، حاملين إرث الثورة العظيم بلا كَلَلٍ ولا مَلَل، رغم الترغيب والترهيب، ورغم التهديدات، والمنافي والسجون؛ إلا أنّا لم نهادن ولم نساير، بل سرنا في دربٍ واحد لم تَلْتَوِ فيه أقدامنا، ولم نغيّر اتجاهنا، وكان ذلك كله - كما نعتقد ونؤمن - من أجل أنّا ننشد لأمتنا الخير، والتطور، والحكم الرشيد، سواء رأى الناس في مساعينا صوابًا، أو رأوه خطأً، أو رأوه بين بين، فالذي أنا منه على يقين أن توجهنا كان كالبوصلة في اتجاه واحد.
أليس هذا الموقف كافيًا ليغمرني بعاطفة نبيلة، وأنا أتحدث عن شقيق، ورفيق طريق؟ هل أستطيع أن أتغلب على عواطفي فأرى الحق كما هو فأتبعه، وأرى الخطأ فأذكره؟ أم أن تلك العاطفة ستحول بيني وبين ما أراه حقاً؟
ولقد تناولت تأثير العاطفة في مواضيع أُخَرى تمت إلى مثل هذا التقديم بصلة، وهنا فقط أضيف أنه إذا كان من الجنوح المعيب، أن أضفي على قريبٍ ما ليس فيه، لمجرد قربه، فإنه من الظلم الفادح أن أغمط حقا هو له، لأن الضرب على إيقاع الأمرين ظلم مبين، ينتج عنه إما اختلاق وقائع، أو طيّ حقائق، وهذا في حد ذاته ليس ظلماً ينزل على الوقائع فحسب، بل على العاطفة نفسها، لإرغامها على طيّ ما تعلم من جميل الخصال، أو المبالغة في المدح أو القدح لمن تحبّ أو تبغض، وأشد الأضرار نزولًا على الحقيقة هو أن الإنسان لا ينطق بما يعتقد، ويبوح به، خشية اتهام عاطفي، لأنه في هذه الحالة يغطي على خصال رفيعة، ويسكت عن كشفها، والساكت عن الحق يُلجم بلجام من نار.
على أن العاطفة النقية والصادقة لها دور محمود في كشف الأخطاء والهفوات التي يراها كاتب ما عند قريب، فيكون لكشفها تأثيرٌ بليغٌ ، على أنّ ما يراه خطأً أو صوابًا قد لا يكون خطأً، وقد لا يكون صوابًا، ولكن ذلك ما يراه هو، وما يراه قابل للنقاش حتى ترسو الحقيقة على موقع مطمئن.
ومن المسلم به أن المرء ُّ يحب لأخيه ما ُّ يحبه لنفسه، ولأنه ُّ يحب لنفسه الصواب، فكذلك ّيحب لأخيه الصواب، وليس من الحبّ أن تبقى الهفوات كما يراها عند صديق وقريب بدون أن يسعى لإبداء رأيه فيها. وأنا ممن يؤمن بأن النقد الموضوعي هو بمثابة توجيه وإرشاد، وإثراء حقيقي، وليس سهماً جارحًا كما يعتقد معظم الناس، ومن ثم فالعاطفة النقية، هي البحث عن الأكمل، وليس التغطية على الخطأ، وإن لم تفعل ذلك فهي مساهمة في التغطية إلى حد بعيد.
صحيح أن تفكيك العاطفة - وهي صلبة - تحتاج إلى عملية ترخي صلابتها وتذيب توتراتها، وفي الإمكان أن تتراجع عاطفة المغيض المحنق عندما يسنح طيف الودّ كما صورّها الشاعر المبدع "إسماعيل صبري باشا" (١٣٤١/ ١٩٢٥م) عندما قال:
إذا مـا صـديقٌ َّ عقنِـي بعِـداوةٍ وفَوقْـتُ سَهْمي في مقاتله سهمي تعّـرَض َطيُـف الُـود َبْينـي َوبْينَـه فكسـرَ سَـهْمي فـانْثَنيت ولم أَرِم فقد عالج عاطفة الانتقام بطيف الودّ ونجح. ومعنى هذا أن العاطفة لها علاج مفيد، وليس من الصعوبة ألا تعالج، وكما أمكن للعقد النفسية أن تعالج عن طريق الاعتراف بوجودها، والإفصاح عنها، والبوح بها، وكشف أستارها، لتتفكك، ويبرؤ حاملها مما كان يعانيه ويرهقه، وكذلك الأمر مع العاطفة، فمتى عرف الإنسان تأثير العاطفة ومدى تدخلها فقد انتهى مفعولها أو خفف منها.
وهذا هو حالي عندما أقدم شقيقي، ورفيق طريقي، فلن تغلبني عاطفة، ولن أقول فيما أراه إلا حقا ما استطعت إلى ذلك سبيلًا .
(2) تقوم شخصية "القاسم بن علي الوزير" على نواحٍ متعددة ومبدعة، فهو شاعر كبير، يقف جنبًا إلى جنب مع "الشريف الرضي" و"بدوي الجبل" يشهد به ديوانه "مجموعات شعرية" ويشهد له جماعةٌ من النقّاد العرب الذين أعرفهم وبُهروا به، وهو شاعر هذا البيت بدون منازع. وهو إلى جانب ذلك أديبٌ بليغُ الأسلوب، ناصع الكلمة، عميق الفكرة ، تشهد بها أبحاثه ومحاضراته في هذا الكتاب، وفي اعتقادي - وبعيدًا عن عواطف الإخاء - أن لديه القدرة العلمية المتمكنة، والتجرد التام من أي انتماء إلا للعلم وحده، وله اطلاعٌ واسعٌ على تاريخ الفكر الإسلامي، والتراث العربي المعاصر وقضاياه ومفاهيمه، وعلى تاريخ الفكر الغربي ومساره مذ نشأته المبكرة، وعلى مضمون مسار الفكر الماركسي منذ ولادته، وله اطلاعٌ واسعٌ على عمالقة الفكر والأدب قديماً وحديثًا، مثل الفكر المعتزلي والفلسفي والأدبي والتاريخي قديماً كمثل الإمام "أبي زهرة" و"مصطفى صادق الرافعي" و"عباس محمود العقاد« و"أحمد حسن الزيات"، وفي الفكر الحضاري تأثر بالفيلسوف "مالك بن نبي". لقد تأثر بهم إلى درجة أنه لو جمع هولاء في شخص واحد لمثّلهم "القاسم بن علي الوزير" خير تمثيل.
وليس بدِعًا بعد تلك الروافد الثرة، أن يتجمع عنده مخزونٌ ضخمٌ من المعارف العلمية، والتحليلات المتينة مكّنهُ من فك الغامض وفتح أقفاله، بطريقة علمية رصينة، خالية من التعقيد، ومن الإسهاب الممل، أو الإيجاز المخل، يسيل قلمه بالممتع من الفكر، والجميل من النثر، والبليغ من الشعر، وهو في كل من الشعر والنثر يهدف إلى إيقاظ الفكر من غفوته، وتصحيح السياسي من انحرافه، وإخراج المجتمع من جمود.
(3) بكل تلك المواهب أضاء "القاسم الوزير" في كتابه هذا زوايا بحاجة إلى تنوير، وأشهد أنه أحسن التحليل، وأنار الطريق لمجتمع يضطرب في أكفان بالية، ولكي نفهم ما قدمته هذه المحاضرات من منافع فلا بدّ من الاطلاع على مجتمع "ما بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية".
فما من شك عندي أن هذه "الإمبراطورية" - على ما بها من أخطاء - كانت تشكل سوراً قوياً حامياً للشرق المسلم من طوفان الاحتلال الغربي، وأن إسقاط السلطان الكبير "عبد الحميد" - آخر السلاطين العظام - كان بفعل انتشار مفاهيم غامضة كائدة انفعالية يغري بها من يريد اقتناصه في حبائله، وبفعل تيارٍ عاصفٍ بغية انهيار السور ليحكم من في داخله، بيد أبناء صُناعِه ومتلقفيه معاً، فتدفـق الطوفان بتلك المفاهيم الكائدة والغّامضة ليمارسها على من هم ضحايا أنفسهم داخل السور، محاولاً بقوة طمس هوية من وقع في قبضته، وتفكيك وحدتهم، وتغيير هويتهم الثقافية والاجتماعية، وهو وإن لم يقدر على طمسها كاملة إلا أنه ألبسها بغموض كثيف لتبقى خلف السور حائرة مضطربة قلقة، مستغلاً تخلف العالم الإسلامي عن حضارته الإسلامية، وعن مفاهيمه الحقيقة ومضامينه الدقيقة والذي أصبح يعيش على أطعمة بالية ظن بها أنه سيقاوم مفاهيم ومضامين حضارة الغرب المغيرة.
ولكي يمرر الغرب مفاهيمه ترك "الديني" يلوك مفاهيمه المنحرفة ليبقى في حالة إرباك أعمى. وفي الوقت نفسه ضخّ مفاهيم مغلفة مطوية غير مفهومة فهماً كاملًا فتسمع لها ضجيجاً، ولكن لا ترى لها طحناً!.
ومن المؤكد عندي، أن الغرب المحتل لم يُرِد أن يقبس الشرق من حضارته علومها التطبيقية ومناهجها التكنولوجية إلا بما قد استغنى عنها وتجاوزها، وإنما كان يقصد مما تجني يداه أن يصهر سلوكه الاجتماعي بمجتمعه الغرائزي ليسهل عليه ترويضه؛ ومن ثم حجب عنه تكنولوجياته.
وأنا أعلم وغيري يعلم أن الإطاحة بالسلطان "عبد الحميد" لم يكن بفعل غزو خارجي نتيجة حرب، وإنما كان بفعل مؤامرة غربية، تلبست بمفاهيم غامضة انصبّت على المجتمع العثماني انصبابًا كبيرًا ، وانتشرت انتشارا واسعًا، أهبت الكثيرين من قطاعات الجيش العثماني فقاموا بانقلابهم على حامي السور، بغية إقامة حكم بدون أسوار، فاختلط الحابل بالنابل وضاعت "الوحدة الإسلامية" وتمزقت "الوحدة العربية" وتقزّمت "تركيا" وتفتت "العرب" نتيجة غياب المفاهيم الواضحة التي لها الدور الأكبر في التحكم في مفاصل الأمة؛ أيّ أمّة!.
وإذن فإن غموض المفاهيم الوافدة تلك قد أنزلت بالشرق المسلم ضربات أبعدته عن أصوله الحقيقيّة وجعلته يحافظ على المتخلف من المفاهيم الإسلامية المنحرفة وتسكنه في محاريب صدئة بالية أو وضعته - بتعبير آخر - داخل أصداف بالية.
وقد حاول "السيد جمال الدين" والإمام "محمد عبده" ومدرستهما التنويرية مقاومة تلك المفاهيم بإحياء المفاهيم الإسلامية البناءة، وشكّل موقفهما وموقف مدرستهما خط دفاع أضعف الهجمة الغربية نوعًا ما، لكنه لم يتغلب عليها لا بسبب من الغرب وحده ولكن بسبب من العرب أيضا حيث صيحة اليقظة جوبهت بصراخ بعض المذاهب المنغلقة، وبحكم المناخ المتخلف فقدت تمكنت من أن تصد تيار الأفغاني وتضعف نموّه. ثم خلف بعد تلك المدرسة شتات في الرؤية قسمتهم قسمين: قسم استمر في التغريب بمفاهيمه الغامضة، ولم يستفيدوا من قسوة التجربة العثمانية، فظلوا يعزفون بقياثير مكررة نفس اللحن ونفس الكلام، ومضى آخرون يلجون في نهجهم المتخلف ويرتلونها في معابد مذاهبهم.
(4) وليس من شك أنّ تحكم المفاهيم الكائدة، والأفكار المبهمة، والثقافة الناقصة، هي التي تخلخل البناء وتضر بقواعده، ومن ثم فإن إدراك هذه الأمور ضرورة لفهم "شروط النهضة" ولفهم الخروج من سراديب الماضي ولمقاومة الكيد الوافد؛ لهذا قام القاسم بن علي الوزير في كتابه هذا ليوضح المخرج من الغموض إلى الوضوح، ومن الخلل إلى الثبات، ومن الأعماق إلى السطوح، ومن بنيّات الطريق إلى السبيل المستقيم: سبيل المعرفة.
ومن المسلم به أن المضامين الواضحة هي خير معين في استجلاء الطريق، لكن المؤسف أنّ المضامين الإسلامية غيرت وبدلت والمضامين الغربية لبسها الكيد - كما قلت - ولو كانتا واضحتين تنطقان بدقة عن محتويهما الحقيقيّين لما احتاج أحد إلى عناء التوضيح، ولكن المشكلة هي أن "المفاهيم"، حتى الآن ماتزال مبهمة، ونحن جميعًا نعرف أن أهم ضوابط السلوك في أي مجتمع كان، هو مفاهيمه ومضامينه، وعلى حسب غموضها ووضوحها، تتحدد طريق مسيره ومصيره، وسلوكه وتفكيره، فإذا ما خرجت تلك "المفاهيم" عن مضامينها، فإن المجتمع بكل منظومته يصاب بالخلل والإعياء.
ومن هنا فإني لواثق أن ما قدمه "القاسم بن علي الوزير" في كتابه هذا وفيما يكتب من فهمٍ دقيق للمفاهيم، وعميق الأفكار، سيجد فيه الناس منارة تهدي للخروج من غياهب مفاهيم منحرفة تعتقت، ومفاهيم أخرى غامضة أضرت.
(5) ولكن كما يقال لكل مفكر آفة، وآفة" القاسم" أنه لا يحبّ أن ينشر كتابًا، ولا مقالًا، ولا محاضرةً ، ولا شعراً، وكم حاول أخونا المغفور له "إبراهيم بن علي الوزير"- رضوان ﷲ عليه- في إقناعه بطبع أبحاثه وبعض أشعاره الكثيرة والمبعثرة في أكثر من مكان، وكذلك حاول أصدقاؤه المعجبين به، فلم يصغ إليهم سمعًا، فحمل "إبراهيم" على كاهله تجميع ما توفر له من جمعها، وطبعها ديوانًا مترفًا بالمعاني الرائعة تحت اسم "مجموعات شعرية" أعادت للشعر قوته، ونبل معانيه، وسموّ أغراضه. وجاء دوري فألححت عليه في طبع محاضراته فتهرّب، فألححت فتعذّر، فلم يبق أمامي إلا أن أجمع ما أمكن جمعه من أوراقه هنا وهناك لطبعه في "مركز التراث والبحوث"، وقد أعانني على جمعها الأخ الصديق والمفكر العروبي صبحي غندور مدير "مركز الحوار العربي"، فله الشكر على ما أسدى.
ثم أسلمت ما جمعت إلى الأستاذ الصديق الفنان "أحمد عاصي" فقام بمراجعة النصوص وتدقيقها، وعمل على إخراجه وإعداده للطبع بأجمل شكل، فله شكر المعترف بحسن ذوقه، وسموّ فنّه، كما أشكر الأستاذ عبد القدوس الحرورة على ما قام به من جهد في طباعته على الكمبيوتر.
وأخيرًا هذا هو الكتاب يخرج بين الناس، وإني لعلى ثقة بأن القارئ سيخرج من مطالعته بلذة الظامئ، ونهم الجائع إلى المزيد من هذه الكتب التي تزوّد الصحارى الغامرة بفيض لا ينضب حتى تطلع أكلها فهماً سوياً، وتزيل من أجوائها عتمة ليل منعقد.
بقلم: زيد بن علي الوزير (رئيس مركز التراث والبحوث اليمني)